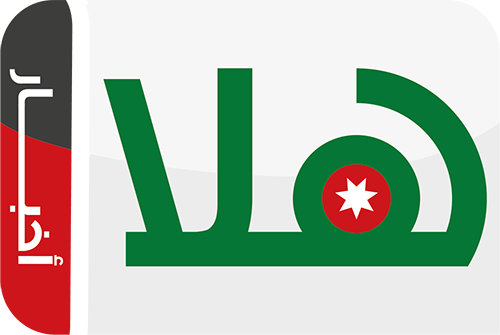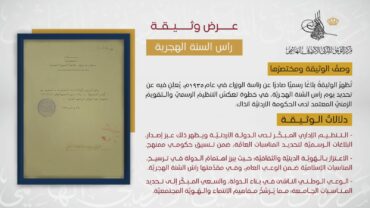مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام يختتم فعالياته

هلا أخبار – اختتم مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام والذي تنظمه الجامعة الأردنية ضمن احتفالاتها بمئوية تأسيس الدولة الاردنية، جلساته العلمية والفكرية اليوم الخميس.
وفي الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة ماجدة عمر، تحدث الدكتور الخضر عبدالباقي من نيجيريا في ورقة بعنوان “التواصل الثقافي بين أفريقيا والاردن: حالة نيجيريا”، مستعرضا أبرز ملامح التواصل بين البلدين والدلائل التاريخية والعلاقات الثقافية المعاصرة.
وتحدث من تونس عبر تطبيق “زووم” الدكتور منير السعيداني في الورقة الثانية بعنوان “سوسيولوجيا التشكيل التاريخي للعقد الاجتماعي: حالات عربية حديثة مقارنة”، مشيرا إلى أن تشكل الدول العربية استند على عاملي العروبة والاسلام.
وبين ان الدول العربية دخلت منعرجا تاريخيا يمكن أن نضعه في مصطلح” الدولة ما بعد الاستعمارية”، رائيا ان المجتمعات العربية تعيش حاليا مراجعة تاريخية وحادة جدا لإعادة بناء دولها.
بدوره، تحدث الدكتور باقر نجار من الكويت “عن بُعد”، في ورقته التي بعنوان “الأردن ودول الخليج العربية”، عن العلاقات الخليجية الأردنية، وقال إن الأردن مثل بالنسبة للكثير من دول الخليج نموذجا إيجابيا، وان العلاقات التي جمعت دول المجلس مع الأردن أوجدت شراكات كثيرة.
ونوه الى أن طبيعة النظام السياسي في الأردن الذي يجمع بين بعض سمات الحداثة وبعض السمات التقليدية والمحافظة كان دوما موضع ومحط إعجاب لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن مملكة البحرين اخذت كثيرا من التجربة السياسية الأردنية فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فيما وجدت دول الخليج العربي في الاردن داعما اساسيا لقضاياها الداخلية.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور شتيوي العبدالله، تحدث الدكتور عصام الموسى في ورقة بعنوان “إعادة كتابة التاريخ العربي باعتماد النظريات الحديثة: الورق العربي انموذجا”، عن دور العرب في تطوير صناعة الورق، مؤكدا ان الفضل يعود في تطوير صناعة الورق عربيا إلى أبو جعفر المنصور في العصر العباسي.
وأشار إلى أن القصة بدأت مع فتوحات العرب المسلمين لسمرقند، حيث اسهموا بدعم صناعة الورق التي كانت قائمة آنذاك، ومن ثم نقلوها إلى بغداد وسائر المدن العربية وقاموا بتطويرها من خلال إضافة النشا على العجينة بحسب كتاب أميركي صادر حديثا.
وأكد ان صناعة الورق هي أبرز أدوات الاتصال التي أسهمت في إيجاد دولة قوية وكبيرة، منوها الى أن تطوير العرب في العصر العباسي لصناعة الورق أسهم كثيرا في تطور النشاط الثقافي وتقدم الصناعات والمهن، كما أدى توفر الورق إلى نشأة الدواوين (الوزارات).
وقدم استاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ساري حنفي، ورقة بعنوان “الدولة المدنية، التدين والعلمنة الجزئية من الأسفل.. دراسة في أربع دول عربية الأردن ولبنان ومصر وتونس”، أشار خلالها إلى وجود تمايزات بالمجتمعات العربية فيما يتعلق بمجلات الدين والثقافة والسياسة الاجتماعية والاقتصادية وهذا التمايز يزيل سوء الفهم بين العلمانية والدين، لافتا إلى أهمية التفكير الأخلاقي في العلاقات الإنسانية.
وكان اخر المتحدثين في الجلسة الثانية الأستاذ في جامعة سن في كوريا الدكتور سونغدون هوانغ، حول “دور الجامعات في تحقيق السلام والرفاه عبر طريق الحرير.. مقترح للجامعة الأردنية”، مستعرضا العلاقة التاريخية التي ربطت الأردن في العصور القديمة مع طرق الحرير، وأنها هيأت أجواء الاحترام المتبادل بين الثقافات المتعددة وأسهمت في ايجاد حالة من السلام والرفاهية.
وأشار الى أهمية الموقع الجغرافي للأردن على امتداد طريق الحرير، مستعرضا أبرز ما يتمتع به الأردن من سمات إيجابية.
وفي الجلسة الثالثة من اليوم الأخير للمؤتمر، والتي جاءت في محورين بقاعتين مختلفتين في الوقت ذاته، ترأس جلسة المحور الأول “العلمي” منها في قاعة وادي رم بمركز اللغات الدكتور خالد الرواجفة، وتحدثت فيها الدكتورة أمل خاروف، في ورقة مشتركة مع الدكتورة هالة الخيمي، عن دور الجامعة الأردنية في تمكين المرأة منذ تأسيسها عام 1962، وكيف تطور تولي المرأة الأكاديمية في المواقع القيادية بالجامعة وتطور المواقع القيادية التي شغلتها المرأة الأردنية داخل حرم الجامعة.
وبينت في الورقة أن المرأة شاركت في المجالس واللجان المختلفة (مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجلس التعيين والترقي، وأمانة سر المجالس)، كما عرضت أبرز العوامل التي ساعدتهن في الوصول إلى المراكز المختلفة.
ولفتت إلى الآثار الإيجابية الواضحة على الجامعة التي نتجت عن توليهن المناصب القيادية، منوهة بالنجاحات والإنجازات التي حققتها الجامعة في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، ومنها في مجال التعليم ورفدها للمجتمع بالكفاءات والبحث العلمي.
بدوره، استعرض الدكتور أحمد الشرايعة، في ورقته، التي حملت عنوان: “تطور الحوسبة وأثرها في المجتمع الأردني خلال المئوية”، مراحل تطور الحوسبة في الأردن مقرونا بتواريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنترنت، والحكومة الإلكترونية، مبينًا مواكبة الأردن للتطورات في مجالات الحوسبة والاستفادة من منتجاتها وخدماتها.
ونوه بنجاح الأردن في إنشاء وتطوير قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات عالية التنافسية، مبينًا أن الأردن يسهم في تصنيع برمجيات تطبيقية وخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويُصدّر لدول عالمية ما نسبته 75 بالمئة من محتوى الإنترنت العربي، و 50 بالمئة من تصميم ألعاب الجوال في العالم.
أمّا الدكتور يوسف العبداللات وفي ورقته المعنونة “الصناعة والأكاديميا ومئوية الدولة”، فأشار إلى أن تأسيس الجامعة الأردنية يعد نقطة التحول والباكورة الأولى لدعم الصناعة لتقود الجهود البحثية والعلمية لتوظيف الصناعة في جميع المجالات وخدمتها.
وتحدث العبداللات عن مشروع “دكتور لكل مصنع” ودوره في الاستفادة من الثروة المعرفية الكامنة وغير المستغلة للأكاديميين المتميزين في الجامعات الأردنية، وتعزيز قدرات العاملين وخبراتهم في المجال البحثي والأكاديمي للانتقال إلى التعليم الجديد القائم على التكنولوجيا والتحول الرقمي وتكثيف الجهود لصيانة المقومات الأساسية في العملية التعليمية، وهي (الطالب، والبيئة التعليمية، والمُدرس والمنهاج) للوصول إلى طرق الإبداع والابتكار وترك النهج التقليدي القديم.
وقال الدكتور علي الشرمان في ورقته التي حملت عنوان: “تطور تصميم الفضاء الداخلي للبيت السكني في المجتمع الأردني”، إن الجانب المعماري والتصميمي يُعدُّ جزءًا من الركن الثقافي لأي دولة في هذا العالم الرحب ولا تبنى الدولة من دونه، كما إنّه جزء من الثقافة المادية ومنشط للثقافة الروحية لدى الإنسان بغض النظر عن عرقة أو دينه أو لونه؛ مؤكدًا أن الثقافة هي مجمل السمات المادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا عن غيره وتشمل: الفنون والآداب، وطرائق الحياة، والحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم، والتقليد والمعتقدات.
وفي الجلسة المتزامنة للمحور الثاني “الطبي” التي ترأستها الدكتورة إنعام خلف، وعقدت في قاعة مؤتمرات كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة، استعرض كل من الدكتور رضوان أبو دامس، والدكتورة حنان جعفر، والدكتور ولهان الشاعر، والدكتورة نداء عبابنة، من مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة مشروع الخلايا الجذعية في المملكة، ومراحل تأسيس المركز الذي افتتحه الملك عبد الله الثاني رسمياً في 2016، والمشاريع العلاجية والبحثية الحالية القائمة فيه.
كما تحدثوا عن المشروعات المستقبلية التي يطمح المركز لإضافتها في مجال العلاج بالخلايا ومشتقاتها وبيولوجيا الخلايا الجذعية.
وفي الجلسة الرابعة من اليوم الاخير للمؤتمر والتي عقدت في قاعة وادي رم بمركز اللغات بالجامعة الاردنية وحمل محورها عنوان “الاجتماعي وترأسها الدكتور إسماعيل الزيود قدّم عضو هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع في الجامعة الدكتور حلمي ساري في ورقة بعنوان “الزواج في الأردن من القرابي إلى الرقمي”، تحدث فيها عن مراحل تطور أنواع الزواج الأردني منذ تأسيس الدولة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاردن شهد زواج الأقارب والزواج الخارجي والزواج المتعلق بالعلاقة مع الزوج الأصلي والعلاقة مع أقارب الزوجة الذين يقتضون زواج الأخ من أرملة أخيه المتوفي، والإجازة لزوج الأخت الكبرى الميتة أن يتزوج بإحدى أخواتها الصغراوات.
كما تحدث ساري عن أنواع الزواج وفقًا لعدد الزوجات الذي يضم تعدد الزوجات والزواج الأحادي، بالإضافة إلى زواج آخر يسمى “المرتب مسبقًا” أو “الأعمى”، وصولًا إلى زواج الإنترنت في يومنا الحاضر وهو الذي يتم من خلاله تعرف طرف ما على الآخر والتواعد فيما بينهما ثم اللقاء قبل أن يتمّ الزواج.
وفي ورقة قدمها مندوبًا عن الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي المدير الفني للمجلس الأعلى للسكان الدكتور غالب العزة، وحملت عنوان “الاتجاهات الديموغرافية والآفاق المستقبلية في الأردن”، لفت فيها إلى أن الأردن يشهد مرحلة تحول ديموغرافي ناتجة عن الاستمرار في انخفاض أعداد المواليد والإنجاب، وانخفاض أعداد الوفيات.
وقال العزة، إن هذه العوامل أثرت على الهرم السكاني وأدت إلى تغير تدريجي في التركيبة العمرية للسكان باتجاه ارتفاع نسبة السكان في سن العمل لا سيما الشباب، وانخفاض معدلات الإعالة بالإضافة الى تدفّق أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل.
وأضاف، أن ذروة هذا التحول ستبلغ أوجها في المئوية الثانية، في عام 2040 عندما ترتفع نسبة السكان في سن العمل الى 67ر7 بالمئة وتنخفض نسبة الإعالة العمرية إلى 47ر7 بالمئة، حيث ستتاح للأردن فرصة تاريخية للاستثمار في رأس المال البشري، كافية لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، الا انه حذر من أنه إذا لم يتم الاستعداد لهذه المرحلة، ولم تُوفَّر فرص العمل وتُتدارك المخاطر فسيكون لهذا التحول الديموغرافي تداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة.
وبدورها، استعرضت أستاذة الجغرافيا الدكتورة صفاء الوديان في ورقتها المعنونة “التحول الحضاري والتغير الاجتماعي في المدن الاردنية، دراسة حالة: مدينة إربد” عددًا من الأرقام والنسب المتعقلة بنمط واتجاه التحضر في الأردن خلال الفترة 1970- 2019، وحجم الأسرة، وطبيعة العلاقة بين أفرادها، ونوع المنزل وحالته، وكثافة الأسرة، وغيرها، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة معايير رئيسة تحدد أسلوب الحياة الحضرية أو ما تسمى بمعايير التمدن وهي المقاس والكثافة وعدم تجانس السكان.
وعرض عضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور أنور الجازي، دراسة بعنوان “أحوال المجتمع البدوي في جنوب الأردن منذ منتصف القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر” أشار فيها إلى الأحوال الاجتماعية للعشائر البدوية في جنوبي الأردن، وبالتحديد في بادية معان منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية وحتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
واستعرض الجازي جانبًا من الحياة الاجتماعية للعشائر خلال مرحلة ما قبل الاستقرار، وجهود الحكومة لتحسين حياة العشائر، وما يتعلق بإصدار القوانين، وتطوير موارد المياه والزراعة في مناطقها، وكذلك في مجالي التعليم والصحة.
وأشار إلى مرحلة استقرار العشائر في تجمعات محددة، والجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل استدامة هذا الاستقرار، ومن أهمها إنشاء المشاريع الزراعية والإسكانية في أماكن تجمع هذه العشائر.
واشتمل المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام ونظمته الجامعة بمناسبة الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الاردنية، على جلسة افتتاحية، و16 جلسة علمية شارك فيها 65 باحثاً اردنياً وعربياً ومن الدول الاجنبية الصديقة، جاءت جلسته الاخيرة ضمن محور “السياسي/الصحي” وترأسها الدكتور اشرف ابو كركي.
وبيّن الباحثان الدكتورة إيمان حماد من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية والدكتور محمد الحدب من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة آل البيت، في ورقة علمية قدّماها في الجلسة بعنوان “نظام الرعاية الصحية في الاردن.. معالم وتحديات واستجابات على امتداد مئة عام”، أن الرعاية الصحية خلال العقود الماضية بقي لها أولوية في الإنفاق الحكومي رغم الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن النظام الصحي الأردني حقق إنجازات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الصحة العالمية كوفيات الأطفال والأمهات ومعدل الأعمار وغيرها، لافتين الى وجود حاجة ملحة لتقنين وزيادة كفاءة الإنفاق الصحي لضمان الاستدامة.
وبين الباحثان الإنجازات التي حققها الأردن في مجال التغطية الصحية الشاملة لمطاعيم الأطفال والحوامل والأطفال تحت 6 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، مؤكدين أن معدل الأعمار والوفيات لدى الرضع والأمهات في تحسن كبير من عام 1960حتّى 2019.
ولفتا إلى أن التعداد السكاني في الأردن في تزايد وخاصة مع أعداد اللاجئين، إذ إنها ستصل إلى 5 بالمئة بشكل سنوي، وأن الإنفاق الصحي للشخص في الأردن في تزايد مستمر أيضا.
وقال مدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب الدكتور سعود الشُرُفات، في ورقة علمية له بعنوان “ظاهرة الارهاب في الاردن خلال مئة عام (1921-2021)، إن البيانات التي توفرت عن ظاهرة الإرهاب في الأردن خلال الفترة منذ تأسيس البلاد عام 1921 حتى عام 2020، والتحليل الإحصائي لها باستخدام تحليل السلاسل الزمنية تُشير إلى أن ظاهرة الإرهاب خلال المئة سنة الماضية من عمر الدولة الأردنية كانت خاضعة لما يسمى “الدوارات الموسمّية”؛ بمعنى أنها كانت مرتبطة بشكلٍ كبير بسيرورة الأحداث والتطورات الجيوسياسية داخلياً وخارجياً؛ نظراً لانغماس الأردن بعمق في سيرورة العولمة؛ إذ يحتل المرتبة (45) على مؤشر العولمة لعام 2020.
ولفت الشرفات إلى أن وضع الأردن كان قد تحسن على مؤشر الإرهاب العالمي عام 2019 بمقدار أربع درجات حيث احتل المرتبة (64) بعد أن كان يحتل المرتبة (60) على مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2018، وأنّه ضمن تصنيف مؤشر الإرهاب العالمي من (مرتفع جدا – متوسط – منخفض – منخفض جداً – غير موجود)، قد صُنّف الوضع في الأردن “منخفضًا”، بعد أن كان “متوسطًا” سنة 2018، وفي عام 2020 ظل ترتيب الأردن ضمن المناطق ذات مؤشر الإرهاب المنخفض؛ لكنه احتل المرتبة 57 عالمياً متراجعا بمقدار 7 نقاط.
وقدّم الباحث في الشؤون السياسية زكريا أبو دامس دراسة تحليلية لتأثيرات الربيع العربي على الاقتصاد الأردني بعنوان “الاردن والربيع العربي، التحديات والفرص”، مشيرًا إلى أن الدول العربية، ومنها دول ما يطلق عليه “الربيع العربي” عجزت منذ سبعينيات القرن الماضي في ظل اتباعها نظام حرية السوق وبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين عن أن تقدم نظاما اقتصاديا تحل به المشكلات التي تواجهها نتيجة اتباعها للنظم الاقتصادية الغربية التي فرضتها المؤسسات الدولية ولم تكن نظما اقتصادية مستقلة داخليًا.
وفي هذا السياق لفت الى أن تطبيق البرامج الغربية قد واكبه مزيد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع في تلك الدول نتج عنها الانتفاضات والثورات العربية.
وقال أبو دامس، إن الثورات العربية التي حدثت في الدول العربية (تونس، ومصر، وليبيا واليمن) أثبتت تأثيرها على الاقتصاد الأردني بشكل سلبي وإيجابي، وأن الاستقرار السياسي في الأردن يشكل عاملاً مؤثرا ورئيسًا في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأردنية في ضوء التداعيات والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية وخصوصاً في سوريا واليمن والعراق.
ودعا لضرورة قيام المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص بمساندة الاردن في تحمل الأعباء بأرقامها الحقيقية التي أثقلت اقتصاده وأمنه جراء استقباله الكم الهائل من اللاجئين السوريين وما خلّفه ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة، تؤثر بمجملها على أمنه الوطني.
وتحدث الباحث في الدراسات الأدبية الدكتور عاطف خلف العيايدة في ورقته التي حملت عنوان “دور الملك عبد الله الأول في إرساء قواعد النهضة الثقافية” عن دور المغفور له الملك المؤسس في النهضة الثقافية منذ بدايات تأسيس الدولة وترسيخ دعائمها في المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن جلالته كان مهتما بالجانب الثقافي اهتماما بالغًا بالإضافة إلى اهتمامه بجوانبِ السياسة والقيادة، فكانَ دائمَ الاطلاعِ الشاملِ على مختلف الفنونِ الأدبية، والتواصل مع المثقفين والشعراء والأدباء، وتقريبهم لديه لمجالستهم، والاستماع إلى كلّ جديدٍ لديهم، وتذوّقِ إنتاجهم الأدبيّ والشّعريّ، ولديه من القدرة المعرفية في أنواع العلوم والمعارف ما تمكنه من بسط آرائه الفكرية والثقافية وإبداء وجهة نظره النقدية فيما يُروى على مسامعهِ.
ولفت العيايدة إلى حرص المغفور له الملك المؤسس على نشر الثقافة مجتمعيا، ومجاراة الدول التي نالت حظّا من الثقافة، وأنه عمد إلى رعاية المثقفين والمبدعين من الأدباء والشعراء في عام 1921، وجمعهم إلى جنبٍ مع السياسيّين والجلساء المقرّبين في بلاطه.